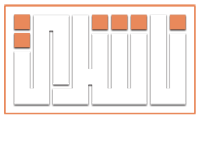عوامل متعددة أسهمت على مرّ التاريخ في نشؤ الدول وتطورها وبناء العلاقات في ما بينها. لعل أبرز هذه العوامل توازن القوى دائما وتوازن الإرادات أحياناً.المقصود بتوازن القوى نزوع كل قوة (دولة) إلى التفوق على منافسيها ببناء نسبة أكبر من القدرات، وبعقد تحالفات مع قوى متجانسة في المصالح والتطلعات للتعادل مع قوة أو تحالف قوى منافسة أو للتفوق عليها. المقصود بتوازن الإرادات نزوع قائد أو مجموعة من القادة داخل قوة (دولة أو حركة ثورية) إلى تعويض النقص في القدرات المادية بالإصرار على إطالة أمد الصراع وتوظيف اكبر مقادير ممكنة من الإمكانات البشرية والمعنوية لإرهاق قوة منافسة على مدى زمني طويل نسبيا من أجل كسر إرادتها والتغلّب عليها أو إكراهها على التراجع.
ثمة حضور لعنصر الإرادة والمعنويات في توازن القوى ، وحضور لعنصر القدرات المادية في توازن الإرادات . إلا أن السمة البارزة في كلٍ منهما هو غلبة القدرات المادية على بقية العناصر في توازن القوى ، وغلبة قوة الإرادة والمعنويات على بقية العناصر في توازن الإرادات.
لعل أبرز مثال على توازن القوى وتوازن الإرادات حرب فيتنام في منتصف القرن الماضي. فقد دارت الحرب بين قوة عظيمة القدرة المادية والعسكرية هي الولايات المتحدة وقوة صلبة الإرادة وغزيرة المعنويات هي ثوار الفياتكونغ . ومع ذلك تمكّن الثوار، من خلال التصميم الصارم على القتال والتعبئة المعنوية العالية وإستخراج نتائج سياسية من الصـراع ( إندلاع جدل حار داخل المجتمع الأميركي حول جدوى الحرب) من كسر إرادة العدو وحمله على التراجع والإنسحاب.
ما قامت وتقوم به منظمات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق يحاكي ما قام به ثوار فيتنام، غير انه لا يصل على صعيد النتائج السياسية إلى ما توصل إليه أولئك الثوار قبل نصف قرن.
ثمة أسباب عدّة لهذا التفاوت في الإنجاز مردّها إلى عوامل موضوعية وأخرى ذاتية . على الصعيد الموضوعي ، نقع على توافر مواقع وموارد ومصالح إستراتيجية ضخمة ومتنوعة للدول الكبرى في المنطقة العربية ، إستوجبت حضوراً عسكريا وسياسياً دائماً وبالتالي إستنزافاً متواصلاً للقدرات السياسية والإقتصادية لبلدان المنطقة وشعوبها . وعلى الصعيد الذاتي ، نقع على توافر إنحطاط وإحباط وقصور مزمن في الذات العربية أبطأت إنبعاث قوى التمرد والتقدم والنهضة ، فضلاً عن إتصاف هذه القوى عموماً بقلة الصبر والنَفَس القصير والخلافات المتناسلة.
لهذه الأسباب ولغيرها جاء التغيّر وأحياناً التطور في منطقتنا نتيجةَ التبدل في توازن القوى بين الدول المتنافسة والمتنازعة والمتصارعة على مواقعنا الإستراتيجية (المضائق) وعلى مواردنا الطبيعية (النفط والغاز) وعلى أسواقنا المتوسعة أكثر مما كان نتيجة إسهامنا الذاتي في عملية النهوض والتطور والتقدم الحضاري. إلى ذلك بلغ من شدة إرتهاننا لتوازن القوى الخارجية ومحدودية إعتمادنا تفعيل الإرادات وتوازنها أننا ما زلنا نعاني تداعيات سقوط السلطنة العثمانية منذ 1918 ، وتقاسم ميراثها بين الدول الكبرى، ونزوع هذه الدول في الوقت الحاضر إلى تجاوز واقع التجزئة الناجم عن إتفاقية سايكس – بيكو إلى محاولة تفكيك الدول الناتجة منه إلى كيانات صغرى ، إستنسابية أو طائفية أو قبلية أو إثنية. أليس هذا ما يحدث اليوم في فلسطين والعراق ولبنان ؟
لا نقع عندنا في مواجهة هذا الخطر التفتيتي الزاحف على ردة فعلٍ صحية وإستنهاضية وتعبوية نوعية . فحركات المقاومة القومية محدودة الفعالية ، وحركات المقاومة الإسلامية أكثر فعالية، لكنها تعاني من "منافسة" الحركات المتطرفة وعنفها الأعمى من جهة وإضطرارها إلى الإنشغال بقضايا الحكم والتعاطي السياسي غير المثمر مع الدول الغازية من جهة أخرى . على ان المشكلة الأخطر تتجسد في علاقاتها مع الفئات الحاكمة بوجوه ثلاثة . الأول ، قصور الفئات الحاكمة في وعي التحديات المستجدة رغم جنوح الولايات المتحدة إلى نقد أدائها وحتى الإنفتاح على معارضيها في سياق تشجيع قوى سياسية أقل محافظةً والتعاون معها . الثاني ، وهو نتيجة الوجه الأول ، مثابرةُ الفئات الحاكمة على إعتبـار المعارضة في الداخل تهديدا ونقيضا أكثر عداوةً لها من أميركا وأوروبا وبالتالي الإستمـرار في محاربة المعارضة وقمعها. الثالث، وهو نتيجة الوجهين الأول والثاني ، إخفاق الفئات الحاكمة في الدول المنتجة للنفط في إدراك معاني القوة والإقتدار الناتجة عن ازدياد عائداتها المالية بعد الإرتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز ، وإمتناعها تاليا عن توظيف هذه القدرات المالية في مشروعات إقتصادية وسياسية على الصعيدين العربي والإسلامي من اجل الإسهام في مواجهة الهجمة الأميركية الصهيونية أو لدعم، على الأقل ، حركات المقاومة الميدانية والمدنيــة (السياسية) لقوى الغزو الخارجي المتواصل.
إن قصور الفئات الحاكمة على النحو المتقدم ذكره يطرح إشكالية تنطوي على مفارقة مضحكة مبكية . ذلك ان إمتناع هذه الفئات عن التطور والتطوير الذاتي مع غياب ضغط فاعل عليها داخل أقطارها من طرف القوى الوطنية والإسلامية الديمقراطية قد يؤدي إلى تشجيع الولايات المتحدة على دعم بعض قوى المعارضة المعتدلة أو الإسلامية والتعاون معها كبديل من الفئات الحاكمة والمعارضة الديمقراطية الإصلاحية أو على حسابها . أليست مفارقة مضحكة مبكية إحتمال إضطرار بعض قوى المعارضة الديمقراطية ، إزاء إمتناع الفئات الحاكمة عن الإنفتاح عليها أو إزاء إمتناعها عن التطور والتطوير ، إلى الرهان على الولايات المتحدة كقوة ضغط على الفئات الحاكمة من اجل الإنفتاح على قوى التغيير والإصلاح ؟ أليس مضحكا مبكيا أن تصبح الولايات المتحدة خصماً وحكماً في آن ؟!
إن إستمرار الفئات الحاكمة في نهجها التقليدي الركودي الراهن وخوفها المقيم من الولايات المتحدة من جهة ، وتراخي حركات المقاومة والقوى الديمقراطية الإصلاحية في الضغط على اميركا لتعديل سلوكيتها من جهة أخرى يشكّل وبالا وقيداً على الأمة في حاضرها ومستقبلها لا يجوز السكوت عنه . من هنا تنبع الحاجة الملحة إلى ضرورة حمل الطرفين ، الحاكمين والمعارضين ، على تغيير موقفهما بإتجاه إعتماد نهج مغاير وموقف فاعل حيال الولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى يخدم مصالح الأمة وتطلعات شعوبها في شتى أقطارها ، لاسيما حيال التحديات والأخطار في فلسطين والعراق ولبنان وسورية.
لتلبية هذه الحاجة الملحة ، ثمة نهج داخلي ممكن إعتماده وموقف خارجي ممكن إتخاذه . أما النهج فهو العمل المباشر للضغط على الفئات الحاكمة بكل الوسائل المشروعة وحسبما تسمح به أو تتيحه ظروف الأقطار المعنية .. أما الموقف فهو عدم الإنزلاق إلى معارضة إمتلاك إيران قدرات نووية تمكّنها من التحول قوةً إقليمية مركزية ، بل النظر إلى هذه القضية في منظور إستراتيجي لأن هذه القوة البازغة ستكون بالضرورة رافداً للأمة ومصالحها وتطلعاتها في وجه قوى الهيمنة الدولية. ألم يعترف جورج بوش في خطبة " حال الاتحاد " أمام الكونغرس الأمريكي أواخر كانون الثاني / يناير الماضي ان الولايات المتحدة هي في حالة حرب مع " الإسلام الراديكالي " ؟ وما الإسلام الراديكالي ؟ أليس هو ، في نهاية المطاف ، المصطلح السياسي الذي تستخدمه إدارة بوش لتوصيف المنطقة العربية بدولها وشعوبها ؟
بإعتماد هذا النهج وإتخاذ هذا الموقف، تُسهم القوى الحية في الأمة ، حاكمين ومعارضين ومقاومين ، في تكوين توازنٍ جديدٍ للإرادات وتغليبه على التوازن الراهن للقوى.