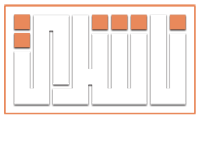الراوي يقف على أطلال المكان والقاريء على أطلال الرواية
غالبا، تكون الكلمات التي يستخدمها الأفراد في الحياة اليومية أقل أهمية من تلك الطريقة التي يلقونها أو يكتبونها بها. فالكثير من الكلمات التي تعبر عن أشياء معينة يمكن توصيلها بسهولة ويسر لانجد لهما مثيلا سوى في التمثيل والإيماء، وكأن اللغة هنا، تقف على مفترق بين اللسان (القول) واليد والجسد ككل (الحركة) والطريقة النهائية التي تتم على أساسها عملية توصيل هذه الأشياء تعتمد على قدرات (الناقل) الذي عبره تصل الأشياء بمعانيها الحقيقية إلى المتلقي. مهمة الناقد أو محب الأدب، شاقة هنا إذا، فلو كان علينا أن نتعاطى مع الأدب كشيء فقط. لأمكن أن نجد أنفسنا في نهاية المطاف مكتفين بتحديدات تقريبية مخيبة للأمل، لذا يبدو مشرعا وضروريا طرح التساؤل عند قراءتنا لأي عمل أدبي يتمحور حول مدى أهمية العمل من جهة ومشروعيته وارتباطه بالأدب (المصنف إليه) من جهة ثانية. الرواية بهذا المعنى، وكذلك القصة وغيرها، تحتاج إلى (ناقل) وهو هنا الكاتب (الروائي) الذي يتمتع بسمات لانجدها عند الفرد العادي الغير "مهتم" وعند الفرد العادي من متلقي الآداب. إلى ذلك، فهو (أي الروائي) يتمتع بقدرات تقنية وأسلوبية تميزه عن غيره من الروائيين ولكنها تتفق معهم في الموهبة وفي القدرة على كتابة الرواية، حيث نعتبر أن السرد ضروري جدا بحسب مايذهب اليه إدوارد سعيد في تخليص الأدب من الترميز. والتميز في النص الجيد هو شرط المنافسة بين أبناء الاتجاه الأدبي الواحد.
في المملكة العربية السعودية. اليوم، موجة من الروايات التي تصدر الواحدة تلو الأخرى على شكل تقصد المنافسة في كتابة الجنس الأدبي المسمى (رواية) وهي منافسة لاتخلو من مشادات وحسد وضيق عين. وهذا الأمر يعطي مشروعية مستقبلية للأعمال الجيدة لا التي في أفضل الأحوال رديئة وفي أسوأها لاتملك بنائية وشروط الرواية.
أحسب أن في المملكة اليوم، زحمة بين الكتاب على إنجاز رواية. وكأن الأمر ضرورة ملحة، فمن هو جيد في القصة القصيرة عليه (برأيي المتواضع) أن يستمر ويطور قصته دون أن يدخل معترك الرواية إذا لم يكن قادراً لعدم توفر الإمكانيات السردية لديه. وعليه أن يكون قاصاً جيداً وريادياً في الفكرة والشكل والمعنى واللغة. ولكن للأسف فإن هذا التمني غير موجود بسبب الطاقة التي للبشر على حب المنافسة بين بعضهم البعض. وكأن المجد هو في الرواية فقط دوناً عن الأصناف الأدبية الأخرى.
ضمن هذا الإطار الموضوعي جدا الذي رسمته تدخل (رواية؟!) كائن مؤجل للقاص السعودي فهد العتيق الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر قبل أيام قليلة في بيروت. وهذا العمل الذي يطرحه العتيق بين يدي النقاد قبل القراء، ممن ذكرت ولم أذكر، ليس عملاً روائياً بالكامل، بل أن الرواية في هذا العمل (مؤجل "ة") على ماذهب العتيق نفسه في عنونة نصه. خاصة، تسميته شخوصه القليلي العدد من منطلق أن الرواية ممكن أن تبنى على مخيلة شخصية واحدة وهذا الأمر يجوز فيما لوكانت سيرة روائية لشخص واحد تتقاطع في حياته قضايا أبعد من مجرد حدود شخصه الموقر. وكذلك النوستالجيا إلى ذاكرة مدينة قديمة "بيوتها طينية" وضيقة حتى على أحلام ساكنيها من فقراء (الرياض) الذين مع بداية الطفرة النفطية التي يقصدها العتيق أصبحوا وبسحر ساحر متوسطي الدخل والحال، وبات عليهم جميعا ترك الذاكرة، والوقوف على (تحولات) المدينة وتغيير نمط عيشهم وحياتهم الشقية (سابقاً) والمرفهة، منذ بدء الطفرة ووجودها حيزا اجتماعيا اقتصاديا، وهي على بدء إقامة مجتمع ينزع نحو الحداثة بدون أن يكون صاحب قدر رائع وخلاب في صنعها.
وعلى هذا، فإن اعتراضي المبدأي على عدم اعتبار هذه (الرواية؟!) رواية بالمعنى الحقيقي غير المزيف. هو أنها اعتمدت بالدرجة الأولى على منطق القصة القصيرة للتحدث عن تحولات مدينة بحجم الرياض، هي اليوم تذهب عميقا في توظيف الحداثة في كل شيء بداخلها، بداية من الشوارع العريضة ونهاية في طريقة عرض الملابس النسائية والرجالية في فاترينات المحال التجارية. واعتقد هنا، جازماً ومؤكداً بأن دعاة رفض الحداثة ومحاربيها، الأشداء ذوي البأس والجسارة، لم ينتبهوا إلى أن الحداثة تأكل كل شيء حولهم، وأنها ليست فقط مصدرة من الثقافة والأدب والفكر، بل هي المعبر عن التحولات الكبرى في الطبيعة المحيطة، والناتجة عن تغير الاقتصاد والهندسة وتغير التخطيط المدني أيضا. فالمدينة بتحولاتها الكبرى والتي لم ينجح العتيق في رصدها بشكل دقيق وعميق، هي المدينة المتحولة من النمط التقليدي إلى النمط الحديث في تركيب المدن. فهو لم يقف في نصه هذا، سوى على رومانسية سمجة لايتضح شكل الحلم فيها أبدا. (تشبه محاولة العتيق هنا، فكرة رواية الفردوس اليباب لمواطنته ليلى الجهني التي تمكنت من الذهاب في النص إلى رومانسية المدينة التي هي في روايتها جدة وليس الرياض وكانت ناجحة جدا
لأنها تمكنت من اللغة قبل كل شيء) وفي حين أن شخصيات العتيق لاتتجاوز أصابع اليد، وهذا ليس هو المهم هنا. فإنه رغم ذلك لم يدخل في التركيب العميق لبنية المجتمع وتحوله من مجتمع محافظ- بقي على حاله - إلى مجتمع يمارس عادات وأشكال الحداثة - دون أي يصبح حداثيا أو يعي الحداثة- وفي الحالين يكتفي العتيق بالعرض فقط، عرض الحال إلى ما آلت اليه الحياة، ولكن سطحيا، دون أن يبذل أي عناء في التحليل البنيوي للشخصيات والأمكنة ودراسة عدم إمكانية تطورها أوحتى إمكانية إنقسامها إلى فئات ويكتفي بالقول (لقد إنقسم إلى فريقين) ص 26.ويستعرضه على شكل إشارة كاريكاتورية وسطحية جدا (هكذا نقلوا حياتهم وأفكار هم وأحلامهم وعاداتهم ومخاوفهم إلى البيوت الجديدة، حتى مدخل البيت وضعوا مجلسا للرجال ومجلسا للنساء، وبابين خارجي وداخلي للرجال، ومثلهما داخلي وخارجي للنساء، داخل بيروت عالية الأسوار؟!) ص 26.الاكتفاء بهذا العرض السطحي جدا للتحول ليس مرده إلى القصد في إظهار السطح على مايبدو لي، ولكن إلى عدم قدرة الراوي على النفاذ أكثر في العمق الذي للأشياء، ويتضح ذلك جليا وكامل الجلاء في ضعف اللغة الروائية وقاموس - السرد- الذين عند العتيق، فضعف السرد الروائي ع
نده لايساعده على التمكن أكثر من الدخول في العمق الذي تكتنزه الحالة التي هو بصدد وصفها روائيا!! هنا، لابد لي من ذكر انطباع أساسي لكي لا أبدو متطفلا وغريباً لايعرف شيئا. في عرض الفكرة عن الرياض التي زرتها، فزائر الرياض، الذي ينتمي إلى فئة تسعى لمعرفة المدينة على حقيقتها وخلع ثوب الحداثة المزيفة والسطحية عنها. يفاجأ بأن هذه المدينة تملك من العادات الاجتماعية الغريبة بنفس ماتملكه من حداثة غريبة ومصطنعة. يفاجأ بأن هذه المدينة التي تتوهج فيها أنوار الأبراج مثل الفيصلية والمملكة والأبنية التي تمكث فيها المحلات التجارية الكبرى، تخفي كذلك بالقرب من مقر الإمارة فيها أعداداً قليلة باقية من البيوت الطينية القديمة خلف سوق "السويلم" الشعبي الذي ذهبت إليه برفقة صديقي وزميلي منصور علي أحمد. وهناك ممكن أن نرى كيف تم بناء هذه البيوت ذات الجدران العالية والتي تقع في نهايتها قرب السقف النوافذ الصغيرة التي تذكر بنوافذ السجون اذا وجدت والتي هي المتنفس الوحيد لهذه البيوت ومن يقطنها.
وأحسب أن هذا الأمر يعود إلى ثقافة وعادات أهل مدن الصحراء- رأيت نفس الشيء في صحراء جنوب الجزائر قبل سنوات- والخوف الذي تثيره الصحراء نفسها. وهذا يتم على خلاف واسع جدا مع منازل منطقةاللحجاز من المملكة التي عادة تكون أكثر انفتاحا على الطريق من خلال النوافذ المشرعة على الرؤية من الخارج والداخل. وهنا بالتحديد لم يدخل العتيق عميقا في التكوين الحقيقي والأساسي للتحولات واحتمالاتها بل بقي على السطح، غير واضح بالنسبة إليه مايخبئه العمق. فالرواية هي فيما هي، فن العبور في غابة من الأفكار والصور والأسماء والبشر ولكن على الراوي أن يحمل في يده ساطوراً يشق به الطرقات الوعرة والصعبة لجلاء السرد.
لم يفلح العتيق في أن يحمل الساطور، كذلك لم يفلح في أن يكتب رواية المدينة التي هي الرياض كما فعل كثيرون في كتابة روايات المدن مثل الأميركي هنري ميلر الذي كتب عن نيويورك ثلاثية روائية (بلكسوس، هكسوس، نكسوس) أوكما فعلت فرانسواز ساغان مع باريس والإنكليزي لورنس داريل الذي كتب عن تحولات مدينة الإسكندرية المصرية عدة روايات مهمة جدا. ويصور العتيق علاقته مع المدينة في جملة هجاء رومانسي يهرب فيها من عجزه عن كتابة نص لايتحدى أو ينافس فيه أحداً بقدر مايتحدى وينافس فيه الرياض المدينة نفسها (لا أحد يسأل عن شيء في هذه الرياض) يضعها على الغلاف الأخير. وأيضا (حتى الوجوه تتشابه، وكل يحدق في وجه الآخر بلا هدف. لكن ماخلق كل هذه النظرات، كل هذه الحجابات) ص 8.كليشيهات كبيرة فقط دون أن يصل إلى تحليل واحد مفيد، إلى قصة، أو إلى نتيجة بحثية، إضافة إلى أنه يستخدم مفردات محلية غير مفهومة للقارئ العربي كثيراً مثل (شاهي) التي لا احد يعرف في العالم العربي أنها تعني (الشاي). وما لفتني كذلك، إخفاق آخر يصور فيه العتيق الأشياء بدون جماليات سردية أبدا، وبدون مخيلة ناضجة في التعاطي مع القضايا التي لها أبعاد جمالية عظيمة. ففي موضوع الجنس الذي هو
أمر بغاية الجمال حين يدخل إلى الأدب، لايحتفظ عند العتيق سوى بالمباشرة الخالية من اللغة والاستعارة وحتى من الحداثة التي وإن كانت لاتعتمد على الجماليات الرومانسية كثيراً إلا أنها لاترفض الجمال بالمطلق، فالحداثة في النهاية قصد جمالي لا أكثر. وهنا يقع العتيق في فخ الجسد بحسب منى فياض وأيضا فخ اللغة السطحية التي يملكها (حين يتصور، مثلا، أنه نائم على ظهره بعضو منتصب، وفوقه فتاة جميلة، تنتظر أن يحتضنها) ص 101.لن أضيف أي كلام.