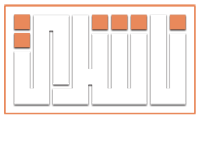(كل فتاة بأبيها معجبة), لم تكن تدري (طفولتي) وقتها سبب هذا الإعجاب, هل لأنني جئت آخر العنقود في أسرتنا ففزت بهذا الحظ الجميل؟ كنت شديدة التعلق به رغم الغموض الذي لم تفهمه براءتي, فلوالدي هيبة خاصة, ورغم هذه الهيبة آنام بين أحضان قلبه الوارف بالحب في هدوء واستكانة. كنت أكثر واحدة في أخواتي من تملك تذاكر التسلل إليه, ليس لأنه مجحف وغير عادل في حبهم, بل لأنني ابنته الصغرى, ومن خلال هذه الرتبة الخاصة كثيرا ما كنت الوسيط بينهم وبين أبي حينما يودون القيام بشيء أو عندما يكونون محتاجين إلى شيء يتطلب الاستئذان, كان يوافق فورًا على طلباتهم إذا كانت مناسبة, وكنت (متمردته الصغيرة) مستغلة صغر سني وترتيبي في الأسرة وقلبه الكبير, وفي يوم من الأيام وددت الذهاب في رحلة مدرسية لم أنبس إلى أبي بكلمة تسللت إلى غرفته ليلاً وأخرجت من جيبه بعض النقود رسوم الرحلة, وفي الصباح الباكر وقبل أن أغادر المنزل أتوجه إلى محطة حافلة المدرسة, تركت له رسالة أخيرة استأذن منه ورقيًا للذهاب إلى هذه الرحلة, هكذا بدأت علاقتي بالكتابة, كان يسميني (الطابع البريدي) لأني كنت كظله لا أفارقه, واصطحبه إلى كل مكان حتى في اجتماعاته مع أهل السياسة وشخصيات التاريخ الجزائري. وأحيانًا يأخذني إلى المحلات لاقتناء ملابس جديدة دون مناسبة محددة, أسأله عن السبب, يجيبني (أن اليوم سأقدم وردًا لوزير آتٍ لزيارة وتفقد أحوال مدينتنا الصغيرة, التي انتشلت مثل كل مدن الوطن من براثن الاستعمار, وأرحب به قائلة: (تفضل الورد يا سيدي الوزير).
مرت الأعوام على هذه الوتيرة وكبر حبي له, لكنني وجدته حزينًا لم يعد يحضر الاجتماعات مع أهل السياسة, كما كان يفعل في السابق. إنه انسحب, فضل مناخًا أكثر هدوءًا وحرية وذكرى إليه. أحب الإشراف على إدارة المدرسة ليكون قريبًا من اللغة العربية التي أحبتها جزائريتي منذ المهد, وفيًا للتدريس الذي كان يقوم به في سجن الاحتلال أثناء الثورة الجزائرية, أو ربما ليتذكر رفقاءه المجاهدين الذين سخروا أنفسهم في سبيل تحرير الوطن.
كبرت أسئلتي دون إجابة, وظل بالرغم من حزنه سعيدًا باختياره, حيث حافظ على عروبة أسرته في زمن كانت الجزائر تقاوم بشدة للتخلص من بقايا الاستعمار.